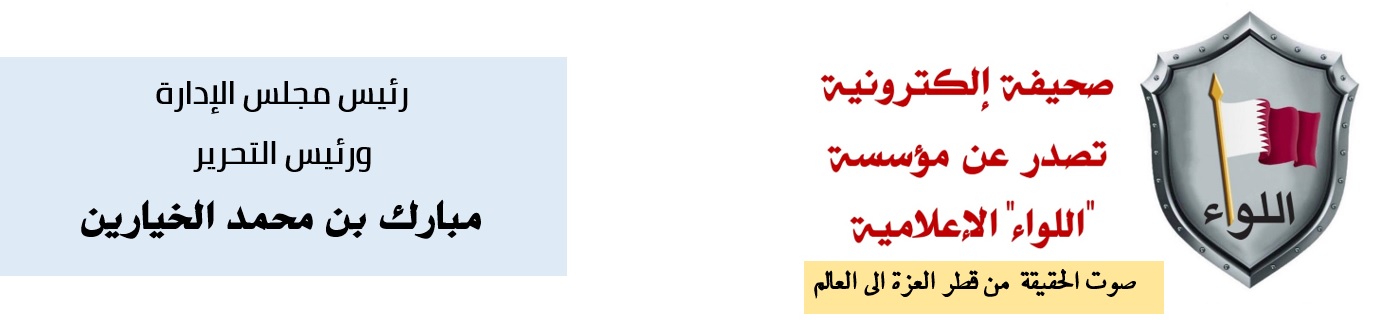تظل أخلاق الفروسية العربية والإسلامية قيمًا سامية تعيش فينا، وفي وجداننا، ولو انتهى زمن الفرسان، فلا نبرحُ إلا ونجد من يتغنى بالفارس وشهامته وعنفوانه ونجدته من جهة، وشدته على العدو وقدرته وقوته من جهة أخرى، وربما تشي هذه المقارنة، بواحدةٍ من أبرز ما وصلت إليها الفروسية الإسلامية، والتي هي امتدادٌ لقيم ومُثُلٍ رسخها الإسلام في العربيّ، بعد أن أزال عنهم ما بقي في صدورهم من الجاهلية، ثم جاءت الشريعة الغرّاء، لتُخرج فرسانًا أثّروا في القاصي والداني، وما فروسية الغرب التي ملئت بها القصص والأفلام السينمائية إلا وليدة لهذه القيم والمثل والعليا، استقوها منا من الأندلس وحروبهم معنا.
وفي الحديث عن الفرسان فقد رسخ في الذهن الغربي السلطان صلاح الدين الأيوبي كأبرز فرسان هذه الأمة في تلك العصور، لما وجدوا منه بعد تحرير القدس من الصليبيين/الفرنجة، من احترام ورعاية وعدل، حتى أنه دفع عن مئات الفقراء من الفرنجة من ماله الخاص الفداء المقرر بعد استسلام المحتلين، بينما خرجت البطاركة من المدينة وهم يحملون صناديق الذهب، وفي الحديث عن القدس تحضر مقارنة ثانية، كيف دخل الصليبيون وقتلوا في الأقصى أكثر من 70 ألفًا، وعاثوا في المدينة فسادًا، في المقابل دخل المسلمون إلى المدينة مستظلين بلواء الشريعة الغراء. وهو ما انعكس على تعلق الغربيين بشخصية صلاح الدين، وقد ذكر بعض المؤرخين الغربيين بأن “أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحياته التي انطوت على البطولة، قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيرًا سحريًّا خاصًّا، حتى إن نفرًا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية، وهجروا قومهم وانضمُّوا إلى المسلمين”.
ومع تراجع حضورنا في العقود الماضية، استوردنا صورة الفارس الغربي، صاحب الكلمة الشريف، إلا أن “طوفان الأقصى” أعاد صورة الفارس العربي الملثم، فأعدنا عقد هذه المقارنات من حيث نعرف أو لا نعرف، وكانت الأيام الماضية مليئة بها، إذ شهدنا نموذجين شديدي التنافر على غرار نموذج الحروب سالفة الذكر، فمن جهة مقاومة ملتحمة مع شعبها، توجه الضربات للعدو، ولكنها ترحم الضعفاء والمرضى والصغار، وفوق ذلك، يحييها الناس ويهتفون لها يقبلون جباه المقاومين ويهتفون باسم قائدها، في مقابل جيش جبان نذل، يقتل الآمنين في منازلهم، ويهدمها على رؤوسهم، يخون العهود والمواثيق، ولا يرقب في العُزّل “إلًا ولا ذمّة”.
وكانت أكثر الصور أثرًا وداع الفرسان من المقاومين للأسرى لديهم، نعم لقد نسج البعض وخاصة من الغربيين قصصًا غرامية حول نظرات الأسرى وطريقة وداعهم للملثمين الميامين، واستعانوا بمتلازمة “ستوكهولم”، ليدللوا على تعلق الأسير بالآسر، ولكنهم تغافلوا عن الدعاية السلبية المسبقة، فقد شوه الإعلام صورة فرساننا في أذهانهم، ولا يرونهم إلا قتلة متوحشين، ولكنهم عندما تعاملوا معهم، وجدوا المعاملة الحسنة، والكلام الرقيق، وغض البصر عنهم، حتى في لحظات الوداع الأخيرة، وهو كما قال أحد الأدباء الكرام في منشوره له: “الخاطف هو المحرر من جو الأكاذيب، ورمزًا للعدالة ونموذجًا للرجولة، فيقع الأسير في هوى آسره لمعاني الكمال في نفسه لا النقص”، ورسالة الأسيرة إلى المقاومين تفيض ثناءً عليهم، على أثر معاملتها الحسنة الطيبة، ولا مجال لإيراد معاملة الاحتلال لأسرانا من النساء والأبطال، فما سمعناه منهم أبلغ من كل كلام.
وهذا أثر فرسان المقاومة على أسراهم، أما عن جمهور الناس، فقد أثّروا في الجموع أيما تأثير، وها هي صور الملثم تُنشر في كل زقاقٍ وشارع، وأصبح القدوة التي يُحتذى بها، يتابعه الفتيان والصغار قبل الشيوخ والكبار، ورسائله مقاطع ينتظرها الناس على أحرّ من الجمر، وأصبح كل مجاهد يظهر مدارًا للتساؤلات الكثيرة، وكأني بها صورة بالغة الشاعرية للفارس النبيل، على صهوة حصانه المطهم، ولكن فارسنا اليوم، يفتك بالعدو، ويحمل هم أمته في وجدانه وبين كفيه، ويكسر آلة القتل بروحه المؤمنة أولًا، وبسلاحه الذي صنع بيديه ثانيًا.
نعم لقد استطاعت هذه المقاومة الباسلة أن تفتننا، وأن تُحيي فينا صورًا كادت أن تضمحل في غمرة سلطة الثقافة المتغلبة، وقرب اندثار النماذج السامية، وفي غمرة هذه “الفتنة” لا يجب أن تكون فتنة “من قطّعن أيديهن” من جمال ما شاهدن، فنقعد عن النصرة والدعم، بل يجب أن يكون إعجابنا كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقودهم إلى التأسي بسيدنا وسيدهم والبذل والتضحية…
والناس في هذا الوقت صنفان، الأول باع لله فأعتق، أما الثاني فقد باع للسلطة والهوى فأوبق…